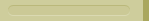ثقافة الرحمة
يقول تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [سورة البلد، الآيتان: 17-18].
الرحمة لغة: الرّقة والعطف.
والمعنى الاجتماعي للرحمة، هو: الشعور بمعاناة الآخر ومساعدته لتخفيفها وتجاوزها.
عادة ما يعيش الإنسان ضغط معاناته الذاتية الشخصية، فحين يصاب بمرض أو ضعف أو حاجة، أو تصيبه مشكلة، أو يقع عليه ظلم، فإنه يشعر بالألم والوجع النفسي، وتضطرب حياته، ويبحث عمّا ينقذه، وعمّن يساعده للخروج من معاناته، وتلك حالة طبيعية.
لكن، ما هو موقف الإنسان عندما يرى معاناة غيره؟
إنّ البعض من الناس قد لا يكترث بمعاناة غيره، ولا يجد نفسه معنيًا بآلام الآخرين، فهو منغمس في ذاته، لا تحرّك مشاعره أنّة مريض، ولا صرخة جائع، ولا استغاثة مكروب، ولا حالة ضعف لصغير أو كبير، وذلك يعني طغيانًا في الأنانية، وتبلّدًا للمشاعر الإنسانية، وقسوة في القلب، تجعله كالحجر أو أشدّ قسوة، على حدّ تعبير القرآن الكريم، في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ [سورة البقرة، الآية: 74].
في المقابل، هناك من يتحسّس آلام الآخرين، ويشعر بمعاناتهم، كأنه يعيشها، فيتعاطف معهم، ويتحرّك لمساعدتهم ليتجاوزا المحنة والعناء.
وتلك هي الرحمة، التي تعني رقة القلب، وطراوة المشاعر الإنسانية، وهي القيمة الأخلاقية العليا، وتأتي في طليعة الصفات الفاضلة النبيلة، لذلك يراها معظم الفلاسفة وعلماء الأخلاق، أنها أساس ومصدر الأخلاق، وهي العنصر الحيوي في كلّ القيم الإنسانية.
محور علاقة الله بخلقه
لذلك اختار الله تعالى صفة الرحمة من بين كلّ أسمائه الحسنى لتكون رديفًا لاسم الذات الإلهية، كما نقرأ في البسملة القرآنية مطلع كلّ سورة ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ﴾، ونقرأ في سورة الفاتحة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢﴾ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣﴾﴾.
وفي آيات عديدة في القرآن الكريم وردت هاتان الصفتان لله تعالى مقترنتين ومنفردتين.
إنّ هذا التركيز والتأكيد على صفة الرّحمة الإلهية، من بين كلّ صفات جلاله وجماله، نابع من أنّ الرّحمة هي القيمة العليا والمحور والمناط في علاقة الله تعالى بخلقه وعباده.
والرحمان والرحيم اسمان مشتقّان من الرحمة، وقد بحث العلماء عن سرّ الجمع بينهما واقترانهما، حيث يرى بعض العلماء أنهما بمعنًى واحد، وأنّ الجمع بينهما للتأكيد.
ويرى علماء آخرون أن (الرحمن) يشير إلى الرحمة الشاملة لجميع الخلائق، و(الرحيم) يشير إلى الرحمة الخاصة ببعض العباد.
أو أنّ (الرحمن) صفته تعالى في ذاته، لذلك لا تطلق على غيره، فلا يوصف أحد سوى الله بأنه رحمان، فهي علم على الذات الإلهية كلفظ الجلالة (الله).
يقول تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ﴾ [سورة الإسراء، الآية: 110].
ويقول تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [سورة الرحمن، الآيتان: 1-2].
ويقول تعالى: ﴿الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [سورة طه، الآية:5].
وآيات أخرى نظيرة لها.
بينما (الرحيم) صفته تعالى في فعله، وإيصال الرحمة إلى خلقه، لذلك لا يمتنع إطلاق هذه الصفة على غيره.
وإذا كانت الرحمة عند البشر تنطلق من مشاعر الانفعال النفسي كالرقة والعطف، وذلك ممتنع على الله تعالى. فإنها من الجانب الإلهي، تعني الإنعام والعون والعفو والمغفرة.
وعلى هذا روي أنّ الرَّحْمَةَ من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميّين رقّة وتعطّف[1] .
ووردت لفظة (الرحمة) بمختلف اشتقاقاتها في القرآن الكريم (339) مرة، فهي من أكثر الصفات الأخلاقية ورودًا وذكرًا في القرآن الكريم.
نشر ثقافة الرّحمة
والآية الكريمة ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴿١٧﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾ [سورة البلد، الآيتان: 17-18] تؤكد على ضرورة نشر ثقافة الرحمة بين أبناء المجتمع، وتحويلها إلى خُلُقٍ وسلوك عام في العلاقات الاجتماعية، بأن يوصي الناس بعضهم بعضًا بالتراحم ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾. لأنّ ذلك يجعلهم أهلًا لليُمن والبركة، ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾، أي يرافقهم اليمن مقابل الشؤم. وهذه نتيجة وأثر وجداني واضح في كلّ تجمع يسود أجواؤه التراحم، فالأسرة التي يتبادل أفرادها الرحمة، تعيش اليُمن والسعادة.
وكذلك أيّ تجمع بشري، كالمؤسسات والشركات والتكتلات، وعلى مستوى المجتمعات الكبيرة.
وهناك تفسير آخر أنّ أصحاب الميمنة هم من يُعطون كتبهم يوم القيامة بأيمانهم، ويكونون من أصحاب اليمين. ومما يؤيّد المعنى الأول مقابلته بأصحاب المشأمة، يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ﴾ [سورة البلد، الآية: 19] أي أصحاب الشؤم والنحس.
تنمية مشاعر الرّحمة
ولكن كيف ننمّي مشاعر الرحمة في النفوس؟
أولًا: خفض مستوى الأنانية في النفس إلى حدّ الاعتدال، وتعزيز الاهتمام بالغير، وذلك يثري نفس الإنسان بالإيجابية، ويؤكد المعنى في حياته، ويرسّخ القيمة الإنسانية في أعماقه.
ورد عن رسول الله  : «لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ»[2] .
: «لا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ»[2] .
وعنه  : «خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ»[3] .
: «خَابَ عَبْدٌ وَخَسِرَ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ فِي قَلْبِهِ رَحْمَةً لِلْبَشَرِ»[3] .
ويقول المفكر الأمريكي مايكل ناجلر[4] : عندما نعاني مع الآخرين ننمو، وعندما نغلق قلوبنا عليهم نموت من الداخل[5] .
ثانيًا: الوعي بطبيعة الذات والحياة، بأنّ يدرك الإنسان أنه معرّض لحالات الضعف والوقوع في ألوان من المعاناة والآلام التي تصيب غيره، وسيحتاج إلى تعاطف الآخرين ومساعدتهم، فإذا مارس الرحمة مع الآخرين، وانتشرت في مجتمعه تقاليد التراحم، فإنه سيحظى عند معاناته بتعاطف يحتاجه، ومساعدة يبحث عنها.
نحن بحاجة إلى معاملة رحيمة من الآخرين، بقدر ما هم بحاجة إليها منّا.
ورد في الحديث عن رسول الله  : «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ»[6] .
: «مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ»[6] .
وعن أمير المؤمنين علي  : «أَحْسِنْ يُحْسَنْ إِلَيْكَ، اِرْحَمْ تُرْحَمْ»[7] .
: «أَحْسِنْ يُحْسَنْ إِلَيْكَ، اِرْحَمْ تُرْحَمْ»[7] .
ثالثًا: ممارسة الرّحمة تعزز مشاعر وسلوك الرّحمة.
إنّ عيادة المريض، وتعزية المصاب، ومساعدة المحتاج، وتفقّد الضعفاء، تُرسّخ مشاعر الرّحمة في النفس، وتعزّزها في السلوك.
روى أحمد في مسنده: أَنَّ رَجُلًا شَكَا إِلَى النَّبِيِّ  قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ
قَسْوَةَ قَلْبِهِ، فَقَالَ  : «امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ»[8] .
: «امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأَطْعِمْ الْمِسْكِينَ»[8] .
إنّ الرّحمة طبع ينبغي أن نتخلّق به، عن طريق الانتظام في ممارسة سلوك الرّحمة مع القريب والبعيد.
رابعًا: التطلّع إلى نيل الرحمة من الله تعالى، حيث تؤكد النصوص الدينية على أنّ من يمارس الرحمة تجاه الناس، تغمره رحمة الله ولطفه.
إنك تحتاج إلى نعم الله وفضله ولطفه في كلّ جانب من جوانب حياتك في الدنيا، وتحتاج أكثر إلى رحمته في الآخرة، والسبيل الأفضل لنيل رحمة الله في الدنيا والآخرة، هو ممارستك الرحمة تجاه الآخرين.
جاء عن النبي  : «مَنْ لا يَرْحَمُ النَّاسَ، لا يَرْحَمُهُ اللهُ»[9] .
: «مَنْ لا يَرْحَمُ النَّاسَ، لا يَرْحَمُهُ اللهُ»[9] .
وعنه  : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ»[10] .
: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي اَلسَّمَاءِ»[10] .
خامسًا: الاقتراب من الرحماء، والقراءة عن سيرهم وتجاربهم، واكتساب الثقافة المشجّعة على التراحم، تخلق اندفاعًا وإقبالًا على ممارسة الرّحمة.
وهنا تأتي أهمية توفير هذه الثقافة في المجتمع، من قبل العلماء والخطباء والكتّاب، وعبر المنابر الدينية، ومناهج التعليم، ووسائل الإعلام.
وللأسرة دور أساس في زرع مشاعر الرّحمة في نفوس الأبناء، عبر التوجيه، والمحاكاة للوالدين، وتقديم النماذج للاقتداء والتأسي.
ويُفترض أن تهتم المؤسسات الخيرية والتطوعية بتوفير الثقافة الدافعة نحو الرّحمة التّراحم.
إنه لا يكفي أن ينمّي الإنسان في نفسه مشاعر الرّحمة، ولا أن يمارسها في سلوكه، بل مطلوب منه إلى جانب ذلك أن يدعو الآخرين إلى التّخلق بالرّحمة ويوصيهم بها. تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾.